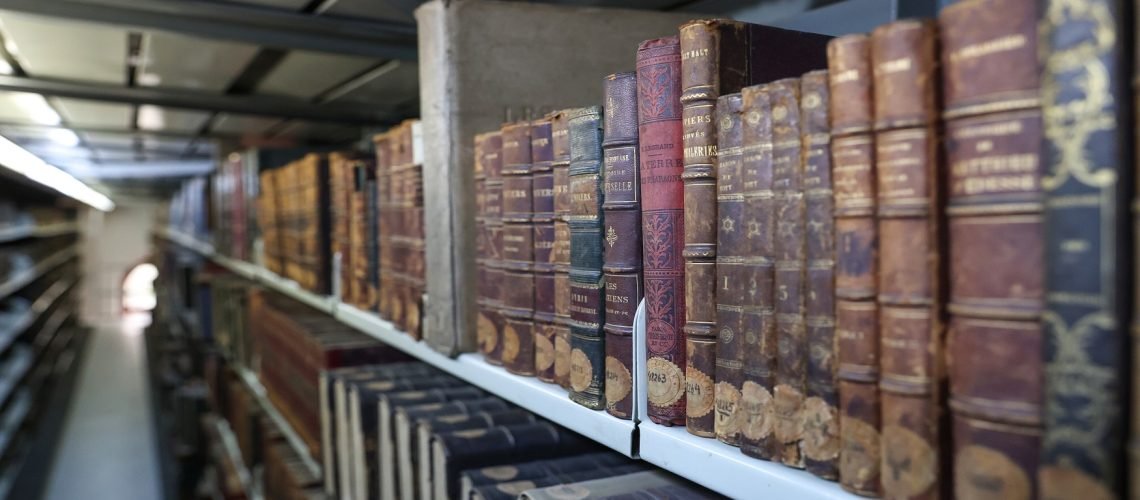ترى الورقة أن تأثير التكنولوجيات الحديثة تجاوز الأفراد وسلوكياتهم الاتصالية، وامتد أيضًا إلى البحث العلمي؛ حيث ظهرت إشكاليات معرفية جديدة تحتاج إلى طرق منهجية ملائمة لتحليلها ومحاولة الإجابة عنها. ولم يكن المجتمع الأكاديمي العربي بمنأى عن هذا الانشغال العلمي؛ حيث حاول الكثير من الباحثين العرب البحث أيضًا عن الطرق الملائمة لدراسة مخرجات تكنولوجيات الاتصال الحديثة، سواء في طبيعة تفاعل الأفراد فيما بينهم، أو انعكاساتها على المجتمع بمختلف فئاته. لكن الأمر لم يكن بالسهولة التي انتشرت بها تلك التكنولوجيات، فالأمر ما زال محلَّ نقاش حاد في الأوساط العلمية العربية حول اعتماد الطرق المنهجية وآليات التحليل التقليدية التي “نجحت” إلى حدِّ الآن في تفسير مختلف الظواهر الإعلامية الناتجة عن وسائل الإعلام التقليدية، أو التخلي عنها ومحاولة إيجاد بدائل منهجية جديدة تتماشى وتلك الوسائل التي تُعد جديدة أيضًا.
الحديث عن وضع التكوين العلمي في مجال الاتصال والإعلام بالمنطقة العربية، وخاصة ما تعلق بالمقاربات المنهجية المعتمدة في دراسة الظواهر الإعلامية والبحث فيها، يجبرنا بوصفنا أساتذة وباحثين في ميدان الاتصال والإعلام أن نعرض الحقائق قصد محاولة تصحيحها، لاسيما أننا في عين العاصفة التكنولوجية التي أنتجت إعلامًا من نوع آخر من حيث حوامله وأبعادها وانعكاساته على أفراد مختلف المجتمعات التي مسَّها. فالإشكال هو في التناول العلمي لهذا الإعلام، فهل نبقى ننتظر ما تجود به علينا المدارس الفكرية من مقاربات منهجية وتقنيات بحث وأدوات تحليل لتطبيقها على مخرجات ما دُرج على تسميته بالإعلام الجديد؟*، أم نحاول نحن أيضًا المساهمة بما أوتينا من معارف أصيلة في علم الاجتماع وعلم النفس وغيرهما من المواد المساعدة على فهم قواعد منهجية في ميدان هذا الإعلام الجديد وإنتاجها، فنحن في حيرة من أمرنا بين الجمود والتقليد أو التحديث؟
لقد أضحى الإعلام الرقمي تحديًا بحثيًّا مهمًّا بالنسبة للباحثين والمهتمين بالظواهر الإعلامية، ولا يقف هذا التحدي عند حدود فهم الظاهرة والتنظير لها فقط، وإنما يمتد إلى كيفية مقاربتها منهجيًّا في سياق الإشكالية التالية: هل ينبغي لنا -نحن الباحثين في مجال علم الاتصال والإعلام- مراجعة الأدبيات المنهجية المتوافرة لدينا حتى الآن في معالجة قضايا الإعلام الجديد أم علينا الحفاظ عليها ومحاولة تكييفها مع واقعنا الثقافي والاجتماعي والحضاري؟
يشكِّل هذا الانشغال حجر الزاوية في النقاش داخل الأوساط الأكاديمية العربية حاليًّا، وكان هكذا كلما ظهرت وسيلة إعلامية؛ إذ ينادي عبرها الباحثون العرب إلى التفكير في المقاربات والمناهج التي يمكن الانطلاق منها في دراسة الإعلام الجديد، وما أتاحه من وسائط وخدمات ووسائل على بيئتنا العربية بخصائصها الحضارية والثقافية التي تميزها. لكن هذه المناقشات لم تتعد الندوات العلمية والملتقيات التي تنظمها كلياتنا ومعاهدنا من حين إلى آخر، أو في إطار أطروحات الدكتوراه عند مناقشتها، فأفضى هذا الوضع إلى بروز وضعين مختلفين لكل منهما مسوغاته وحججه، كما سنبين لاحقًا.
قبل عرض آراء كل فريق ومسوغاته من الاعتماد المنهجي على ما تمليه المدارس الفكرية الغربية، أو الاجتهاد في تأصيل أخرى في مقاربة الظواهر الإعلامية الاتصالية عندنا، ينبغي أن نرصد الوضعية العلمية في جامعاتنا ومخابر بحثنا وكلياتنا فيما يخص الإعلام الجديد، عسى أن نفهم أهمية الإشكالية السابقة وأهمية البحث فيها.
لعهود طويلة، اعتمدنا -نحن الباحثين العرب- في مقاربة الظواهر الإعلامية -حتى تلك التي تخص مجتمعاتنا العربية- على مدرستين فكريتين أساسيتين، هما: المدرسة الأميركية والمدرسة الأوروبية، إلى جانب بعض المدارس الأخرى من مختلف الروافد. ويقول الأكاديمي نصر الدين لعياضي في هذا الشأن: “إن الخطاب عن تكنولوجيات الاتصال في المنطقة العربية يتغذَّى من الكتابات النظرية التي أنضجتها السياقات الاجتماعية والثقافية المختلفة عن السياقات التي تميز المنطقة العربية، ويوظف الكثير من المفاهيم، مثل: “الفضاء العام”، و”المجتمع المدني”، و”الفجوة الرقمية”، وغيرها كمسلَّمات وليس كمفاهيم إشكالية”(1). إننا على وعي بأن الكثير مما تنشره هذه المدارس لا يتوافق في الكثير من الأحيان مع بعض الأوضاع الإعلامية في منطقتنا العربية، لكننا كنا دائمًا نحاول -قدر المستطاع- تكييف معارف هذه المدارس مع طبيعة ظواهر الإعلام الجديد، الذي صار يتغلغل في النسيج الاجتماعي والثقافي للأمة العربية. لكن هذا المسعى، لم يصل إلى درجة الحديث عن مدرسة عربية في ميدان الاتصال والإعلام، رغم وجود أصوات كثيرة تنادي بضرورة قيام مدرسة عربية في علم الاتصال والإعلام.
فإذا وضعنا جانبًا الأبعاد الفكرية المعتمدة في بحوثنا الإعلامية، فإن الحديث يخص بالذات المقاربات المنهجية الأكثر انتشارًا في الأوساط الأكاديمية، فكل المحاولات البحثية للإعلام الرقمي وما يدور في فلكه من أوضاع اتصالية، ما زالت تعتمد إما على مقاربة كمِّية على النمط الأمبريقي، وإما على المقاربة الكيفية على نمط البنائية الاجتماعية، مع ميول كبير للمقاربات الكمِّية عند الكثير من الباحثين العرب، لأننا -كما يقول نصر الدين لعياضي- تعوَّدنا على تجنب مساءلة الترسانة المنهجية التي نستخدمها في البحث، فيصعب علينا التشكيك في التيارات الفلسفية والمعرفية التي انبنت على أساسها هذه الترسانة، والتي أطَّرت تفكيرنا، وحدَّدت أطر مداركنا(2).
1. اعتبارات منهجية
اعتمدت الدراسة على مسح التراث العلمي المنهجي (المسح الوثائقي)، الذي توفره كليات الإعلام وأقسامها في المنطقة العربية من أطروحات الدكتوراه (جامعة القاهرة، جامعة الشرق الأوسط، الجامعة الافتراضية السورية، جامعة الجزائر 3..)، والمقالات العلمية التي تُصدِرها مختلف المجلات المتخصصة في موضوع الإعلام الجديد، مثل: مجلة جامعة دمشق (سوريا)، ومجلة الدراسات الإعلامية (ألمانيا)، ومجلة بحوث العلاقات العامة (مصر)، ومجلة علوم الإعلام والاتصال (الجزائر)… كما اعتمدت أيضًا على مسح مختلف مخرجات المؤتمرات واللقاءات العلمية التي انعقدت حوله، لاسيما تلك التي عالجت مشاكل المناهج والتقنيات التي من شأنها مقاربة موضوع الإعلام الجديد وآلياته (مؤتمر وسائل التواصل الاجتماعي (السعودية)…). فقد توافرت للباحث أكثر من 250 دراسة وبحثًا في هذا الموضوع، سمحت له بتكوين رؤية عن طبيعة الوضع العلمي الأكاديمي فيما يخص الإشكالية المطروحة سابقًا.
واستعملت الدراسة أيضًا إلى جانب المنهج المسحي، تقنية المعاينة وخاصة العيِّنة المتاحة التي تُعد من العينات غير الاحتمالية، حيث تعامل الباحث مع ما توفره قواعد البيانات، خاصة العربية منها (المنصة الجزائرية للمجلات العلمية، موقع البيانات الرقمية الأكاديمية…) من دراسات ومقالات وأطروحات وكتب وملخصات المؤتمرات والندوات وأيام دراسية في مختلف ربوع المنطقة العربية.
ولتحديد متغيرات الإشكالية السابقة، اختار الباحث أهم الدراسات والأطروحات لتكون أمثلة فسَّر في ضوئها مختلف الآراء والمواقف والتوجهات المنهجية السائدة في الأوساط الأكاديمية العربية فيما يخص موضوع الإعلام الجديد، لذلك فإن الجداول المعتمدة في هذه الدراسات، ما هي إلا عينات فقط منها.
2. وضع الاعتماد أو التقليد
يرى أصحاب هذا التوجه أن العلم له خاصية عالمية (Universel)، وبالتالي ليس هناك علم خاص بدولة أو منطقة بعينها. فما دام أن الإعلام الجديد يسع كل المعمورة فقد صار بذلك خاصية إنسانية لها مدخلات ومخرجات واحدة مقارنة بالإعلام التقليدي من حيث كونهما يلتقيان في المفهوم والمبادئ العامة والأهداف. فهو -أي الإعلام الجديد- امتداد وتطور طبيعي للإعلام التقليدي الذي صار في وقتنا الحالي يعتمد بدرجة كبيرة على الإعلام الإلكتروني(3).
أما من الناحية المعرفية، فإن الإعلام الجديد ما زال يحافظ على المفاهيم نفسها التي كانت تشغل بال الباحثين في الميدان، فما زال السلوك، والاستعمالات، والحاجيات المشبعة، وطبيعة التلقي، وطبيعة المحتويات المعروضة… من أهم المواضيع جلبًا لاهتمام الباحثين في مجال الإعلام الجديد. وعلى هذا، فإن المنهج المسحي وأداة تحليل المضمون وطريقة سبر الآراء عبر الاستمارة أو الدراسات الكيفية بالمنهج الإثنوغرافي والتحليل السيميولوجي على سبيل المثال، لا تزال صالحة لمقاربة الظواهر الناجمة عن ومن الإعلام الجديد، طبعًا مع تكييفها مع متطلبات كل بحث. ويرى الباحث الفرنسي، دومينيك فولتون (Dominique wolton)، أنه من المفيد إدراج التنظير لآثار شبكة الإنترنت ضمن مختلف النظريات التقليدية، لأنه لا يمكن بأية حال من الأحوال أن تنفصل الميديا الجديدة عن مسيرة تطور ظاهرة التواصل الإنساني في مختلف تجلياته(4). ويرى الباحث في مجال الثقافة الرقمية، محمد السيد ريان، في كتابه: “الإعلام الجديد”، أن “الإعلام الجديد هو بمنزلة تطور طبيعي للتقنيات الإعلامية التقليدية، والتي تفرض سنن الحياة والواقع والتكنولوجيا تطورها لتلاءم وتواكب مجريات الحياة المعاصرة والسريعة والجديدة”(5).
إن التراث المعرفي الذي شكَّل المنبع الأساسي لتفسير الظواهر الإعلامية الاتصالية ولفترة طويلة لا يزال المحرك الأساسي لمختلف البحوث والدراسات الخاصة بوسائل الإعلام وعملها، سواء على مستوى الأفراد أو المجتمع. وقد تجلى هذا التراث المعرفي في مدرستين أساسيتين ومختلفتين شكَّلتا القاعدة الأساسية لمختلف النظريات التي تبلورت في شأن علم الإعلام، وهما: المدرسة الوظيفية والمدرسة النقدية. فالأولى تصب فيما اقترحه هارولد لاسويل (Harold Lasswell) حول وظائف وسائل الإعلام التي لخصها في مراقبة البيئة، وربط أجزاء المجتمع، ونقل التراث من جيل إلى آخر، إضافة إلى وظيفة الترفيه، والتي نجدها مجتمعة في وظائف الإعلام الجديد. وعليه، فالمدرسة الوظيفية لا تزال قادرة على تشكيل المرجع النظري لكل محاولة لتفسير عمل الإعلام أو وظيفته، بطريقة أمبريقية مستمدة من الواقع القابل للملاحظة والقياس.
على الضفة الأخرى من الاعتماد، نجد المدرسة النقدية بقيادة كل من تيودور أدورنو (Theodor Adorno) وماكس هوركهايمر (Max Horkheimer)، وهربرت ماركوس (Herbert Marcuse)، ثم بعد ذلك يورغن هابرماس (Jürgen Habermas) وميشال فوكو (Michel Foucault). وقد اقتربت هذه المدرسة من دراسة الإعلام الجديد بالتوجهات نفسها التي قاربت بها الإعلام التقليدي، أي البحث عن طبيعة الهيمنة، والعقلانية، وعدم المساواة. كل ذلك اعتمادًا على مقاربة كيفية (المنهج الإثنوغرافي على سبيل المثال، أو الملاحظة، أو المقابلة)، لأنها الأدوات الوحيدة التي يمكن من خلالها معرفة المفاهيم السابقة في سياقاتها المختلفة حسب هؤلاء، ومنه فهم مكونات الإعلام الجديد وعمله بأكثر موضوعية.
وإلى وقت قريب من هذه الأطروحات، لا يزال الاعتماد واضحًا على الأطر النظرية الكلاسيكية لمقاربة الإعلام الجديد، فقد توصلت دراسة قام بها الباحث حلمي محسب سنة 2007(6)، وباستعمالها أداة تحليل المستوى الثاني (الثانوي)، أن البحوث المصرية والأميركية على سبيل المثال، ما زالت تعتمد على النظريات الكلاسيكية الخاصة بالإعلام التقليدي في تفسيرها للموضوعات الإعلامية المرتبطة بالإنترنت. كما أشارت دراسات أخرى إلى أن الكثير من البحوث العلمية في المنطقة العربية، وفيما يخص الإعلام الجديد، ما زال يعتمد على نظرية الاستخدامات والإشباعات بوصفها نظرية مُفسِّرة لدوافع استعمال الأفراد للإعلام الجديد. كما نجد الاستمارة الاستبيانية أداة منهجية لقياس جمهور وسائل الإعلام التقليدية مستعملة بكثافة في دراسة مستخدمي الإنترنت وما يدور فيه من أنظمة، كما قام الكثير من الباحثين العرب باستعمال تحليل المضمون عندما يريدون استنطاق مضامين الإعلام الجديد (انظر عينة من تلك الدراسات في الجدول أسفله).
نفهم من هذا الطرح أن الإعلام الجديد لا يحتاج أكثر من المقاربات الكمِّية أو الكيفية لدراسة وظائفه الجديدة وتحليلها، مع مناداة البعض بمحاولة تكييفها لتكون أكثر مرونة مع مختلف أشكال الاتصال التي يفردها الإعلام الجديد. فالخريطة المنهجية الحالية -إن صحَّ التعبير- لمقاربة الإعلام الجديد، لا تزال قائمة على المنهج المسحي الذي يُعد من أكثر المناهج استعمالًا في بحوث الإعلام الجديد، سواء في مسح المضامين أو مسح الجمهور (المستخدمين)، أو مسح الوسيلة في حدِّ ذاتها.
3. التجديد في المناهج والتقنيات المنهجية لدراسة الإعلام الرقمي
على نقيض الرأي السابق، يرى بعض الأكاديميين، مثل: عبد الله الزين الحيدري ومي العبد الله والسيد بخيت وغيرهم، أن نظريات الإعلام الكلاسيكية بصفة عامة، والمقاربات المنهجية التي تقترحها، لم تعد صالحة نظرًا لاختلاف البيئة الإعلامية الجديدة عن البيئة الإعلامية التقليدية وعلى أكثر من مستوى. فالبيئة النظرية التي تتشكَّل من خلالها المعاني والبنى المعرفية للجمهور تختلف اختلافًا جذريًّا مع البيئة التقليدية، فالجمهور والمضمون والشكل… عناصر تتسم بالتفاعلية على العكس من البيئة التقليدية التي تُنعت بالأحادية. من جهته، ذكر الأكاديمي عبد الله بن صالح الحقيل أن الإعلام الجديد ليس تطورًا أو امتدادًا للإعلام التقليدي، وإنما هو وسيلة جديدة لها ظروفها ومتطلباتها وعملياتها المختلفة. كما أن للإعلام التقليدي ظروفه وعملياته المختلفة أيضًا، بينما الخطأ يكمن في محاولة الإعلام التقليدي تبنِّي أو تقليد الإعلام الجديد، وهذا غير ممكن لأنهما صيغتان مختلفتان. وبيَّن الحقيل أن الإعلام الجديد أخذ من التقليدي كثيرًا من المهام والوظائف لعدم قدرة الإعلام التقليدي تقنيًّا القيام بها، كما أن الاعلام الجديد هو إعلام تفاعل اجتماعي، وعلاقة الإعلام التقليدي مع جمهوره تخلو من التفاعل الاجتماعي ولا يستطيع الوصول إلى هذا المستوى، لكنه يستطيع بل يجب عليه التأثر بالإعلام الجديد(7).
وقد أشار معهد السلام الأميركي، عام 2010، إلى أن الأطر النظرية والمنهجية المتوافرة حاليًّا تبدو غير كافية لتفسير أثر الوسائط الجديدة في حياتنا رغم أنها تبدو واضحة(8)، ذلك لأنها حديثة النشأة من جهة، وشديدة التعقيد والتطور من جهة أخرى، حتى صار من الصعب مواكبة هذا التطور؛ إذ يظهر في كل يوم العديد من البرامج والتطبيقات ناهيك عن العديد من الابتكارات الاتصالية التي يخلقها المستخدمون، والتي تُحدِث تأثيرات من الصعب أيضًا تفسيرها ودراستها عن قرب. لهذا تقف أمام الباحثين إشكالات نظرية وأخرى منهجية استلزمت منهم إيجاد بدائل نظرية ومنهجية لها تتوافق مع بنية هذه الوسائط وطبيعتها، وكذا طبيعة التطورات التي تعرفها(9). ومن جهته، يرى دينيس ماكويل (Denis McQuail) أن ثمة تطورات هائلة في ممارسة الاتصال من خلال الإعلام الجديد، والتي تستدعي الانتقال إلى مرحلة جديدة في التنظير، تُقَدَّم فيها أفكار أكثر عمقًا لفهمه، لأن النظريات الحالية المتمحورة حول الوسيط غير كافية(10). وقد قادت هذه التغيرات إلى ظهور دعوات عديدة لإعادة النظر في مناهج البحث المستخدمة التي تناسب الإعلام التقليدي، وتقديم نماذج ومناهج جديدة تتسق مع الفرضيات والمفاهيم المستجدة التي ظهرت مع الإعلام الجديد، وفي مقدمتها “التفاعلية” التي أولاها هؤلاء الخبراء اهتمامًا كبيرًا تمثَّل في محاولة بعضهم تطوير مقاييس علمية لقياس “التفاعلية” في العملية الإعلامية، ومن هؤلاء كاري هيتر (Carrie Heeter) (1989)، وشيزاف رفايلي (Sheizaf Rafaeli) وفاي سودويكس (Fay Sudweeks) (1997)، وعبد الله بن صالح الحقيل (2011).
ولئن كانت القطيعة مع التراث النظري التقليدي غير واضحة المعالم، فإنها تبدو واقعًا ملموسًا من خلال مجهودات تنظير جديدة سعى أصحابها لإيجاد منطق نظري ومنهجي آخر أكثر عقلانية في فهم مكونات الإعلام الجديد ووظائفه المختلفة وتحليلها؛ فأنتجت تلك المجهودات الكثير من النظريات، مثل: نظرية الشبكة (Network Theory)، ونظرية الشبكة الفاعلة (Actor–Network Theory)، ونظرية الألعاب على الشبكة (Gaming or Ludology Theory)، وغيرها كثير.
ويقود هذا الحديث إلى موضوع المقاربات المنهجية الواجب الاستعانة بها في دراسة الإعلام الجديد، فإلى وقت قريب استعانت دراسات وأبحاث كثيرة في هذا الميدان (انظر الجدول رقم 1) بالمناهج والأدوات والتقنيات الكلاسيكية التي كانت معتمدة في دراسات الإعلام التقليدي لمقاربة ودراسة الإعلام الجديد. لكن نتائجها كانت دائمًا محلَّ شك مع صعوبة تطبيقها بشكل مماثل على الوسائط المختلفة وتفسير مختلف ظواهرها، التي تتسم بكثرة التطور والتعقيد، علاوة على الأوضاع الاتصالية التي تظهر عند استعمال الفرد تقنياتها، وكذلك مقدرة الباحثين على الإحاطة بمستعملي الإعلام الجديد من حيث طبيعتهم الاجتماعية ومستواهم العلمي وجنسهم ومختلف تصرفاتهم الاتصالية عند التعرض له. ففي كثير من الدراسات وجد الباحث أن هذه المسائل ما زالت تخضع إلى تقنيات إحصائية (العينة القصدية مثلًا) ومعادلات رياضية قد تُظهِر الكثير عن المستخدمين، لكنها لا تعرف عنهم إلا ما تُظهِره تلك الإحصائيات والأرقام.
وفي ضوء ما سبق ذكره من نقائص في استخدام المقاربات المنهجية التقليدية عن موضوع الإعلام الجديد، فإن الاعتماد عليها ما زال حاضرًا في الكثير من الدراسات العلمية، خاصة في الأطروحات العلمية التي تَستخدم لحد الآن، في معظمها، الأدوات المنهجية نفسها المستعملة في دراسة الإعلام التقليدي.
4. موقع العرب من إشكالية التقليد والتجديد في مناهج البحث
رغم التراث العلمي الذي تزخر به الأمة العربية وفي ميادين مختلفة، إلا أنه لم يشكِّل قاعدة معرفية لبروز نظرية أو أنظمة منهجية لمقاربة الإعلام الجديد. فلا نكاد نجد نظرية عربية تُطرح بديلًا للنظريات الفكرية الغربية فيما يخص موضوع الإعلام الجديد والتكنولوجيا الحديثة للاتصال، فجلُّ التراث النظري والمنهجي المتحكم في البحوث العلمية الخاصة بهذا النوع من الإعلام عندنا، ينطلق من مفاهيم ومقاربات منهجية أُنتجت هناك، أي في نطاق النظرية الوظيفية والنظرية البنيوية والنظرية النقدية وغيرها من النظريات التي أُسست على إثرها الكثير من الدراسات لمختلف وسائل الإعلام. وهو ما نتج عنه بالضرورة اعتماد الباحثين العرب على ما تقترحه هذه النظريات من مناهج وتقنيات في دراسة الإعلام الجديد كما رأينا ذلك سابقًا، حتى إنها لم تخرج عن ازدواجية الطرح بين البحوث الكمِّية والبحوث الكيفية: الأولى: نجد تحت مظلتها المنهج المسحي بمختلف أنواعه، مثل تقنية تحليل المضمون، والثانية: الدراسات النقدية والمنهج الإثنوغرافي والتحليل السيميولوجي على سبيل المثال.
لقد سار الوضع العلمي في المنطقة العربية على المسار السابق عقودًا طويلة، أي منذ ظهور الحركة الإعلامية في المنطقة العربية في ثلاثينات القرن الماضي، وامتدت حتى وقتنا الحالي؛ إذ ما زالت الدراسات الإعلامية تعتمد على المقاربات السابقة نفسها في دراسة الميديا الجديدة وتحليلها، وحتى وإن كان بعضها رائدًا في محاولته تفسير عمل الميديا الجديدة وكيفية تعامل الأفراد معها، وآثارها على سلوكياتهم ومواقفهم، لكنها في حقيقة الأمر لا تشير ولا تفصح عن الوضع الاجتماعي والثقافي الذي يتطلب تطبيق مناهج تحليلية نابعة من الثقافة العربية وحقيقتها الحضارية. وفي هذا الاتجاه، يقول الأكاديمي جمال زرن: “وهنا يكمن الفرق التاريخي بين الغرب والمنطقة العربية في تعريف الإعلام الجديد وهو ما يدفعنا إلى الإفصاح أنه لا وجود لإعلام كوني جديد أو إنساني بل إن البيئة الثقافية والاجتماعية لهذا المجتمع أو ذاك هي التي تحدد طبيعة الإعلام الجديد وخصوصياته